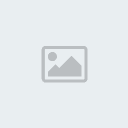من العبارات الموهمة قول بعضهم: "مصلحة الدعوة تقتضي ذلك".
يقولون ذلك في مقامات يبررون فيها مخالفتهم لشرع الله تعالى، والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الكلمة طاغوتاً يبرر لهم المخالفات الشرعية!
وهذه الكلمة إذا استعملت في محلها بحسب الشرع لا بأس، أمّا إذا استعملت تبريراً للخروج عن الشرع فإنها تؤول إلى القاعدة الميكافيلية: "الغاية تبرر الوسيلة". كيف يكون من مصلحة الدعوة مخالفتها؟ وهل يصح أن يقول مسلم: أنا أسرق لأتصدق؟! الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
ويكرر بعض المشتغلين بالدعوة كلمة (مصلحة الدعوة)، وقد يتخذها بعضهم سُلّماً يتوصل به إلى تحقيق أهداف أو تصورات فردية له، أو أهداف لجماعة أو حزب ينتمي إليه، فيتوصل باسم الدعوة إلى ذلك!
والحقيقة إن مصلحة الدعوة محكومة بالشرع، وإهدار الشرع في ذلك هو إهدار للدعوة، ووقوع في مستنقع النفعية، حيث تكون الغاية تبرر الوسيلة!
ولذلك ضبط العلماء المصلحة المعتبرة شرعاً، بأنها المندرجة تحت مقاصد الشرع، ولا تعارض الكتاب والسنة، و القياس الصحيح، و لا تفوت مصلحة أهم منها!
فهل يصح أن يقال: يجوز الكذب والغيبة والنميمة لمصلحة الدعوة؟!
هل يجوز أن تؤكل أموال الناس بالباطل بدعوى مصلحة الدعوة؟!
هل يصح أن تزيف الحقائق ويكتم الحق بدعوى مصلحة الدعوة؟!
سبحان الله!!
كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟!
فليس من ديننا (الغاية تبرر الوسيلة)؛ بل هذه عبارة جرت عند الغربيين العلمانيين الذين لا يضبطون أنفسهم بدين، ونحن (أعني : المسلمين) ديننا وشرعنا وعقيدتنا تضبطنا، فلا يجوز لنا من الوسائل إلا ما هو جائز شرعاً، قال الله تبارك وتعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف:108).
ومصلحة الدعوة هي في تطبيق الشرع، والمصالح المرسلة يراعى فيها تطبيق قاعدة قيام المقتضي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدمه، فإن قام المقتضي لفعلها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم مع عدم المانع، فتركها سنة، وإن قام مانع من فعلها مع قيام المقتضي لفعلها فإن زوال المانع يبيح فعلها. فإن لم يقم المقتضي لفعلها أصلاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي المصالح المرسلة، والنظر فيها للعلماء يوازنون بين المصالح والمفاسد، يراعون مقاصد الشرع وأحكامه، وليست لكل أحد!
ومراعاة المصلحة من الدين، بل إن مقاصد الشرع تدور على جلب المصالح ودفع المفاسد، ولكن إذا لم يكن الداعية مقيداً نفسه بشرع الله، فإن ضابط المصلحة عنده يصيبه من الخلل ما الله به عليم، فيعود لا يرى مصلحة إلا في حدود ذاته وتحقيق الرياسة لها، أو مصلحة جماعته أو تنظيمه الذي ينتمي إليه، وصار ولاؤه لغير الله ورسوله من حيث لا يشعر!
أمّا أن يأتي الشخص لأمر فيه تحقيق مصلحة لنفسه أو لجماعته أو لمن يحب، فيقول: هذا من مصلحة الدعوة، فلا!
ومثل هؤلاء الناس إذا أوذي في دعوته أو نسب إلى الخطأ يطلب الانتصار لنفسه، ويغذى الشيطان غضبه، ويحرك غروره، فصار يجعل نفسه هو مقياس الدعوة، ويظن أنه إذا تراجع عن الباطل والخطأ تأثرت الدعوة، واهتزت صورتها في أنفس الناس، فيريه أن من مصلحة الدعوة عدم الرجوع والتسليم للحق؟
قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية (5/254ـ257 باختصار وتصرف يسير): "إن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله، وقصده طاعة الله فيما أمره به. وهو يحب صلاح المأمور، أو إقامة الحجة عليه، فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله!
وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا.
ثم إذا رُدَّ عليه ذلك (يعني: ما فعله لطلب رياسة نفسه أو طائفته) وأُوذِي أو نسب إلى أنه مخطىء وغرضه فاسد؛ طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي!
وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة، إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه، وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم؛ وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه. ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد!
فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله! ...
ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (سورة الأنفال:39). فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة.
وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله.
وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة دين، أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا؛ لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله!
فكيف إذا كان الذي يدّعي الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟!
وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا ولهذا قال تعالى فيهم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (سورة البينة: 4-5 )، وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة (سورة البقرة: 213) ... وقد قال في سورة يونس (آية19): وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقا"اهـ
من كتاب العبارات الموهمة للشيخ الفاضل محمد عمر بازمول حفظه الله
وحدة وحدة
اعداد:ابو اميمة محمد74
يقولون ذلك في مقامات يبررون فيها مخالفتهم لشرع الله تعالى، والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الكلمة طاغوتاً يبرر لهم المخالفات الشرعية!
وهذه الكلمة إذا استعملت في محلها بحسب الشرع لا بأس، أمّا إذا استعملت تبريراً للخروج عن الشرع فإنها تؤول إلى القاعدة الميكافيلية: "الغاية تبرر الوسيلة". كيف يكون من مصلحة الدعوة مخالفتها؟ وهل يصح أن يقول مسلم: أنا أسرق لأتصدق؟! الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
ويكرر بعض المشتغلين بالدعوة كلمة (مصلحة الدعوة)، وقد يتخذها بعضهم سُلّماً يتوصل به إلى تحقيق أهداف أو تصورات فردية له، أو أهداف لجماعة أو حزب ينتمي إليه، فيتوصل باسم الدعوة إلى ذلك!
والحقيقة إن مصلحة الدعوة محكومة بالشرع، وإهدار الشرع في ذلك هو إهدار للدعوة، ووقوع في مستنقع النفعية، حيث تكون الغاية تبرر الوسيلة!
ولذلك ضبط العلماء المصلحة المعتبرة شرعاً، بأنها المندرجة تحت مقاصد الشرع، ولا تعارض الكتاب والسنة، و القياس الصحيح، و لا تفوت مصلحة أهم منها!
فهل يصح أن يقال: يجوز الكذب والغيبة والنميمة لمصلحة الدعوة؟!
هل يجوز أن تؤكل أموال الناس بالباطل بدعوى مصلحة الدعوة؟!
هل يصح أن تزيف الحقائق ويكتم الحق بدعوى مصلحة الدعوة؟!
سبحان الله!!
كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟!
فليس من ديننا (الغاية تبرر الوسيلة)؛ بل هذه عبارة جرت عند الغربيين العلمانيين الذين لا يضبطون أنفسهم بدين، ونحن (أعني : المسلمين) ديننا وشرعنا وعقيدتنا تضبطنا، فلا يجوز لنا من الوسائل إلا ما هو جائز شرعاً، قال الله تبارك وتعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف:108).
ومصلحة الدعوة هي في تطبيق الشرع، والمصالح المرسلة يراعى فيها تطبيق قاعدة قيام المقتضي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدمه، فإن قام المقتضي لفعلها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم مع عدم المانع، فتركها سنة، وإن قام مانع من فعلها مع قيام المقتضي لفعلها فإن زوال المانع يبيح فعلها. فإن لم يقم المقتضي لفعلها أصلاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي المصالح المرسلة، والنظر فيها للعلماء يوازنون بين المصالح والمفاسد، يراعون مقاصد الشرع وأحكامه، وليست لكل أحد!
ومراعاة المصلحة من الدين، بل إن مقاصد الشرع تدور على جلب المصالح ودفع المفاسد، ولكن إذا لم يكن الداعية مقيداً نفسه بشرع الله، فإن ضابط المصلحة عنده يصيبه من الخلل ما الله به عليم، فيعود لا يرى مصلحة إلا في حدود ذاته وتحقيق الرياسة لها، أو مصلحة جماعته أو تنظيمه الذي ينتمي إليه، وصار ولاؤه لغير الله ورسوله من حيث لا يشعر!
أمّا أن يأتي الشخص لأمر فيه تحقيق مصلحة لنفسه أو لجماعته أو لمن يحب، فيقول: هذا من مصلحة الدعوة، فلا!
ومثل هؤلاء الناس إذا أوذي في دعوته أو نسب إلى الخطأ يطلب الانتصار لنفسه، ويغذى الشيطان غضبه، ويحرك غروره، فصار يجعل نفسه هو مقياس الدعوة، ويظن أنه إذا تراجع عن الباطل والخطأ تأثرت الدعوة، واهتزت صورتها في أنفس الناس، فيريه أن من مصلحة الدعوة عدم الرجوع والتسليم للحق؟
قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية (5/254ـ257 باختصار وتصرف يسير): "إن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله، وقصده طاعة الله فيما أمره به. وهو يحب صلاح المأمور، أو إقامة الحجة عليه، فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله!
وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا.
ثم إذا رُدَّ عليه ذلك (يعني: ما فعله لطلب رياسة نفسه أو طائفته) وأُوذِي أو نسب إلى أنه مخطىء وغرضه فاسد؛ طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه وربما اعتدى على ذلك المؤذي!
وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة، إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه، وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم؛ وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه. ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد!
فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله! ...
ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (سورة الأنفال:39). فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة.
وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله.
وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبهة دين، أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة وهو الحق وهو الدين، فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا؛ لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله!
فكيف إذا كان الذي يدّعي الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟!
وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا ولهذا قال تعالى فيهم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (سورة البينة: 4-5 )، وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة (سورة البقرة: 213) ... وقد قال في سورة يونس (آية19): وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقا"اهـ
من كتاب العبارات الموهمة للشيخ الفاضل محمد عمر بازمول حفظه الله
وحدة وحدة
اعداد:ابو اميمة محمد74