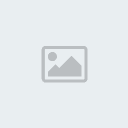[size=28] ضوابط النظر في النوازل والمتغيرات في اجتهادات الفقهاء للدكتور / صالح بن حميد
مقدمة
لعل من المناسب التقديم بكلمات مختصرة, وإشارات موجزة حول ضوابط النظر في النوازل والمتغيرات في اجتهادات الفقهاء وكلام أهل الأصول - رحمهم الله – مربوطاً ذلك بخوض بعض المعاصرين المنتسبين إلى الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي, مما يستدعي ترسيخ النظر في الضوابط, وتأكيد ثوابت الشرع المطهر, مع وفائه التام بحاجة البشرية في كل مستجداتها ونوازلها.
نزلت شريعة الإسلام وحياً من عند الله تبارك وتعالى تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الإعتقاد ويرسي قواعد العدل والمصلحة, والرحمة في الأحكام واستقامة السلوك.
وخلود الشريعة, وكمالها, وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت منضماً إلى ذلك مجالات الاجتهادات النابعة من أصالة الفكر في تفهم النصوص ومقرراتها, وفي حسن تطبيقها في كل ما يجد في الحياة من وقائع, وما يلم بها من تطورات ومتغيرات بسبب إحداثات الفكر الإنساني, وتلوث البيئات والتحولات في المجتمع وما تقتضيه سنن الله في هذا.
والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع, كل ذلك طريقه, إما النص في المنصوص عليه, وإما فهم النص فيما لم ينص عليه, ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصيف, المدرك لعلم الشرع الشريف.
وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي:
"وأشرف العلوم ما ازدوج فيها العقل والسمع, واصطحب فيه الرأي والشرع. وميدان هذا علم أصول الفقه, فإنه يأخذ في هذا سواء السبيل, فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول, ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له عقل بالتأييد والتسديد".
وذلكم هو ميدان الاجتهاد من أجل تحصيل الحكم الشرعي في مسألة غير من منصوصة.
وبتعبير آخر : هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
والاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص, وفي طريقة تطبيق حكمه, أو في مسلك ذلك التطبيق على ضوء الملاءمة بين ظروف النازلة التي يتناولها النص, والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه.
يوضح ذلك شمس الدين ابن القيم في عبارة سلسة مبيناً نهج الصحابة - رضوان الله عليهم – فيقول:
"...فالصحابة - رضي الله عنهم – مثلوا الوقائع بنظائرها, وشبهوها بأمثالها, وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها, وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد, ونهجوا لهم طريقة, وبينوا لهم سبيلة".
وليس المقصود بالاجتهاد التفكير العقلي المجرد, فهذا ليس منهجاً مشروعاً, بل هو افتئاب على حق الله في التشريع, حتى ولو كان جاداً بعيداً عن الهوى, مادام أنه لم ينطلق من مفاهيم الشرع, ومبادئه, وأصوله, وحقائق تنزيليه, ومثله العليا ومقاصده الأساسية.
ومن أجل هذا فإن نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل في فهم النصوص الشرعية, وتطبيقاتها, ودلالتها, وقواعد الشرع المرعية.
يقول أبو حامد الغزالي:
"اعلم أن العلم في قسمين: أحمدهما شرعي, والآخر عقلي, وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها, وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها(ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).
فالعلوم الشرعية أكثرها عقلي؛ لأنه لا بد فيها من استعمال طلاقة العقل
وكذلك أكثر العلوم العقلية شرعي عند التحقيق, لأنه لابد من مراعاة قيد الشرع
والجمود والتقليد لا يكونان فقط بالكف عن استعمال العقل, وإنما يكونان أيضاً بالفصل بين ما هو شرعي وما هو عقلي, والاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ فعدم استعمال العقل في الشرعي جمود وتحجر, وكذلك عدم الاهتداء بالشرع في العلوم العقلية جمود وتحجر،
لأن الحق الواصل عن طريق الوحي لا يتعارض مع الحق الواصل عن طريق العقل الصحيح بالبحث والنظر".
مصادر التشريع
ومصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس,
ثم بعدها مصادر توصف بالمصادر التبعية, أي أنها مبنية على هذه المصادر ومنبثقة منها وفي إطارها لا تعدوها ولا تخرج عنها.
-من أبرز هذه المصادر التبعية وما يتعلق بها:
المصلحة المرسلة,
والعرف,
والاستحسان,
والاحتياط, وسد الذرائع,
وقاعدة الضرر والضرورات, وعموم البلوى
, والاستصحاب,
والبراءة الأصلية,
والمقام ليس مقام بسط للحديث عن هذه المصادر كلها.
-وفي مدخل هذا الموضوع يقال:
إن هذه المصادر من العرف, والاستحسان, والمصلحة هي المحك الدقيق والمرتقى الصعب في النظر فيما بسطه علماء الأصول والقواعد - رحمهم الله – حينما بحثوا في أعراف الناس وحاجاتهم وضروراتهم, وأثر المتغيرات والأحداث على استمساكهم بدينهم, وانتظام أمور معايشهم, فكان ذلك معتركاً دقيقاً يجب التثبت فيه على ما سوف يتبين إن شاء الله.
-وعليه فإن الحديث سيكون متناولاً مسألتين رئيسيتين:
أولاهما:
استعراض لبعض هذه المصادر التي تعد قواعد أساسية ينبني عليها التغير والتجديد, مع إنهاء الحديث في كل مصدر بما يضبطه بخصوصه.
ثانيتهما:
ضوابط عامة في النظر في المتغيرات.
أولاً :
استعراض لبعض المصادر في التشريع :
سوف يقتصر الكلام على المصادر التالية:
(المصلحة المرسلة – الاستحسان – سد الذرائع والاحتياط – عموم البلوى – العرف).
1-المصلحة المرسلة:
هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسها, بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة. وليست هي المصلحة الغريبة التي لم يشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياساً, ولا لجنسها حتى تكون استدلالاً مرسلاً, فهذه الأخيرة ليست حجة عند أحد من الأئمة, والغزالي الشافعي, والشاطبي المالكي يحكيان إجماع أهل العلم على رد المصالح الغريبة’ ويُدخلانها في باب الاستحسان الذي رده الشافعي – رحمه الله – وشدد النكير على القائلين به, وهو غير الاستحسان الذي روي عن مالك وأبي حنيفة – رضي الله عنهما – والأخذ به. فهذا الأخير استدلال بنص, أو إجماع, أو عرف, أو مصلحة في مقابلة عموم أو قياس. وهو الذي ستأتي الإشارة إليه.
غير أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لابد فيه من أمور :
الأول :
أن تكون معقولة بحيث تجري على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول.
الثاني :
أن يكون الأخذ بها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين؛ بحيث لو لم يأخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج شديد.
الثالث :
الملاءمة بين المصلحة التي تعد أصلاً قائماً بذاته وبين مقاصد الشارع, فلا تنافي أصلاً من أصوله, ولا تعارض دليلاً من أدلته, بل تكون منسجمة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها, بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها.
والمصلحة أو الاستصلاح باب واسع ومدخل عريض, قد يدخل منه من لا يفقه في الشريعة ولا يدرك مراميها, ومن أجل هذا منع منه من منع من المجتهدين خشية من هذا الباب.
ومن المقرر والمعلوم أن الشريعة تراعي مصالح العباد, وباب الاجتهاد مفتوح فيما لا نص فيه, ولكن للاجتهاد شروطه وللمصلحة ضوابطها وحدودها.
فليس مرد المصلحة إلى تقرير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد, فإذا حسب الناس أن التعامل بالربا – مثلاً – قد بات مصلحة نحتاج إليها, ولا يقوم أمر الناس إلا بها, فهو بمقتضى هذا الضر مصلحة حقيقية, وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم أن تتسع لقبول هذا الحكم, لأنه قد رأى ذلك علماء في الاقتصاد, وخبراء في التجارة من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها.
وقد يرى بل قد يتفق علماء التربية وعلماء النفس على أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب الأخلاق, ويخفف من شدة الميل الجنسي, ويمكن من استخدام كافة القوى البشرية المتاحة من أجل التنمية, فلا يبقى نصف المجتمع معطلا, فهو مصلحة ينبغي تحقيقها والشريعة تراعي تحقيق المصالح.
وقد يقول الأطباء : أن لحم الخنزير ليس بمستخبث, وإن أكله لا يعقب أي آثار سيئة في الخلق والجسم.
إن تقدير ما به يكون الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها, قد وضع ذلك في مقاصد الشريعة الخمسة وهي: حفظ الدين, وحفظ النفس, وحفظ العقل, وحفظ النسل, وحفظ المال.
وبناء عليه؛ فإن كل ما توهمه الناس مصلحة مما يخالف تلك الأسس العامة في جوهرها, أو الترتيب فيما بينها, أو يخالف دليلاً من الأدلة الشرعية من كتاب, أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح ليس من المصلحة في شيء, وإن توهمه من توهمه.
أما نتائج خبرات الناس وتجاربهم فيجب عرضها على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة, فما وافقها أخذ به, والحكم في ذلك للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة, وما خالف ذلك فيجب طرحه وإهماله واعتباره مصلحة ملغاة.
ويجب أن يفهم أن الشارع لم يلغ مصلحة دلت عليها تجارب الناس وعلومهم, بل الواقع أن تقدير هؤلاء المجربين والخبراء للمصلحة كان خطأ, صاحبه خلل نابع من هوى في نفس المجرب, أو خطأ في وسائل التجربة, أو نقص في الاستقراء, فنحن نتهم تقدير هؤلاء, ولا نتهم نصوص الشريعة.
نخلص من ذلك إلى أن الخبرات العادية, والموازين العقلية, والتجريبية المحضة لا يجوز أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد وتنسيقها.
إن مدار المصلحة التي ينبني عليها الحكم الشرعي هي المصلحة الشرعية, والمصلحة الشرعية ليس لها طريق غير الوحي.
أما المصلحة الدنيوية فلا اعتبار لها في نظر المسلم عند مخالفتها للنص الشرعي.
2-الاستحسان:
عرفه ابن رشد المالكي فقال:"إنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه, فيعدل عنه في بعض المواضع, لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع".
وعرفه أبو الحسن الكرخي الحنفي حيث قال:"هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول".
فالاستحسان نوع من الترجيح بين الأدلة, وحقيقته كما يلاحظ, وكما يصرح به كثير من الأصوليين أنه أخذ بأقوى الدليلين.
أنواع الاستحسان:
ينقسم الاستحسان من حيث ابتناؤه على الأدلة الشرعية إلى أربعة أقسام:
أ.الاستحسان بالنص:
وذلك يجري في كل أنوا العقود التي قالوا أنها على خلاف القياس كالسلم, والإجارة, والقرض ونحوها. وهي استحسان بالنص لأنها قد ثبتت بنصوص شرعية على غير وفق القاعدة العامة من عدم صحة بيع المعدوم, وعقود الربا, ونحو ذلك. وأغلب إطلاقات الاستحسان في كتب الفروع تتصرف إلى هذا النوع, وعلى الخصوص في فروع الحنفية,فيقولون هذا جائز استحساناً, ويسمونه الاستحسان بالنص.
ب.الاستحسان بالإجماع:
أي أن الاستحسان هو الإجماع كما في مسألة الاستصناع.
ج- استحسان الضرورة:
كما في مسألة الحياض والآبار؛ ووجه الاستحسان في هذه المسألة أن الماء إذا خالطته نجاسة ولو كان كثيراً فإنه ينجس مادام ليس جارياً, ولكن عفي عن ذلك استحسانا للضرورة, وبيان ذلك: أن القياس يأبى طهارتها. لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء, فلا يزال يعود وهو نجس, ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي, وكذلك خروج بعضه عن الحوض, وكذا الماء ينجس بملاقاة الآنية النجسة, والنجس لا يفيد الطهارة, فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة, فإن الحرج مرفوع بالنص. وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس.
د- الاستحسان بمعنى القياس الخفي:
وقد سمي قياساً خفياً في مقابلة القياس الجلي, وهو القياس المصطلح عليه. والاستحسان بهذا المعنى يقصدون به ما قوي أثره. ومن أمثلته طهارة سؤر سباع الطير, فالقياس الجلي أن سؤره نجس, لأنه من السباع. ودليل النجاسة حرمة أكل لحمه كسائر السباع. وفي الاستحسان هو طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا كالصيد, وكذلك الانتفاع بجلده وعظمه, ولو كان نجس العين لما جاز كالخنزير, وسؤر سباع البهائم إنما كان نجساً باعتبار حرمة الأكل لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها, ولعابه متولد من لحمها, وهذا لا يوجد في سباع الطير لأنها تأخذ الماء بمنقارها, ومنقارها عظم, وعظم الميتة طاهر, فعظم الحي أولى. فصار هذا الاستحسان وإن كان باطناً أقوى من القياس وإن كان ظاهراً, وهذا النوع من الاستحسان هو الذي يغلب إطلاقه عند الأصوليين.
3. سد الذرائع والاحتياط:
سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه, فما كان وسيلة إلى الحرام يحرم, وإن كان في أصله حلالاً, ومعنى هذا الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدي فيها إلى مالا يجوز. فعقد البيع حلال مشروع في أصله لقوله تعالى ( وأحل الله البيع )
ولكن قاعدة سد الذرائع تقتضي بطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم, أو كان الباعث الدافع إليه غير مشروع, كما في بيع السلاح لمن يقتل مسلماً, أو لأهل الحرب, وبيع العنب لمن يتخذه خمراً.
أما الاحتياط :
"فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه".
مجال الأخذ بالاحتياط:
والمكلف يأخذ بالاحتياط في مجالين:
الأول :
تحقق الشبهة.
الثاني :
حصول الشك في الحكم الشرعي.
المجال الأول: تحقق الشبهة:
الشبهة التي تعرض للمكلف في الأحكام الشرعية قسمان:
القسم الأول: الشبهة الحكمية:
وهي التي تقع في الحكم الشرعي بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن, وهي متوجهة إلى الحكم الشرعي نفسه من حل أو حرمة وغيرهما من أقسام الحكم الشرعي, لذا سميت بالشبهة الحكمية, وهذا يحصل غالباً حين تتعارض الأدلة لدى المجتهد.
القسم الثاني: الشبهة المحلية:
وهي التي ترد على المحكوم فيه الذي هو محل الحكم من حيث دخوله تحت حكم الشارع من حل أو حرمة أو غير ذلك. كاشتباه ميتة بمذكاة ومحرمة بأجنبيات وهو أنواع:-
1-اشتباه بعدد محصور: كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو مذكيات محصورات, أو رضيعة بعشر نسوة فهذه شبهة يجب اجتنابها بالاتفاق.
2-حرام محصور بحلال غير محصور: كما لو اختلطت الرضيعة بنساء البلد, فلا يجب اجتناب نكاح نساء أهل البلاد.
3-حرام لا يحصر بحلال لا يحصر: كاختلاط الحلال بالحرام في أسواق الناس, والأسواق فيها المغصوب, والمسروق, والربوي, مما يقل ويكثر, حسب ورع أهل الزمان, ولا يقال بالمنع من التعامل مع أهل الزمان, أو البلد ما لم يقترن بالأعيان علامات تدل على أنه من الحرام, فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام, فتركه ورع, وأخذه حلال, لا يفسق به آكله.
المجال الثاني:
الشك في الحكم الشرعي الطارئ بسبب الشك في الواقع: فيطرأ الشك في الحرمة والوجوب أو الإباحة فيحتاط المكلف لنفسه فانه لا يخرج من عهدة الواجب- مثلاً- إلا بيقين أو ظن غالب. كالشك في عدد الركعات .
والنظر في ذلك في أربعة أقسام:
1- التحريم معلوم ثم يطرأ الشك في الحل, فهذه شبهة يجب اجتنابها, ويحرم الإقدام عليها, كما لو رمى صيداً فوقع في الماء فيخرج ميتاً, ولا يدري هل مات بالغرق, أو بسبب جرح الرماية.
2- الحل معلوم ثم يطرأ الشك في التحريم, حكمه الحل, فلا ينجس الماء بمجرد ظن النجاسة.
3- الأصل التحريم ثم يطرأ ظن غالب على الحل, كمن يرمي صيدا فيغيب عن ناظره ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى أثر رميه, فهو حلال, وان احتمل أنه مات بسبب شدت السقوط.
4- الأصل الحل ثم يطرأ ما يفيد غلبت الظن التحريم, كما لو رأى حيواناً يبول بماء كثير ثم وجد الماء متغيراً واحتمل أن يكون الماء قد تغير بطول المكث فيحكم بنجاسة الماء.
على أن الاحتياط في جملته مطلوب فيما علم أمره وتحقق فيه يقين اختلاط الحلال بالحرام أو ظن غالب, وذلك بقرائن وعلامات توصل إلى ذلك, كما لو كان في بلاد غير المسلمين أو مع فساق لا يتورعون عن اقتراف المنهيات, أما إذا كان في ديار المسلمين, ولم يظهر ما يدعوا إلى الاشتباه فلا ينبغي التدقيق والإلحاح في الأسئلة مع أعيان المسلمين, بل قد يصل الأمر إلى تحريم السؤال إذا كان فيه إيذاء للمسلم المستقيم.
4-عموم البلوى :
يظهر عموم البلوى في موضعين:-
الأول : ماتمس الحاجة في عموم الأحوال , بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة .
الثاني: شيوع الوقوع والتلبس , بحيث يعسر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة.
ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة, وفي الثاني ابتلاء بمشقة الدفع.
الضابط في عموم البلوى :
يرجع النظر في عموم البلوى إلى ضابطين رئيسين:-
الأول:
الضابط في نزارة الشيء وقلته:
أي أن مشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به قد يكون نابعاً من قلته ونزارته, ومن أجل هذا عفي عن يسير النجاسات, وعن أثر الاستجمار في محله, عما لا يدركه الطرف , وما لا نفس له سائلة ونيم الذباب(ما يخرج من فضلاته), وما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز عنه , وما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.
الثاني:
كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره:
كما أن عموم الابتلاء ومشقة التحرز قد تكون نابعة من تفاهة الشيء ونزارته, كذلك قد يكون الأمر لكثرته وشيوعه فيشق الاحتراز عنه ويعم البلاء به.
وقد نبه الغزالي إلى أن الغلبة التي تصلح عذراً في الأحكام ليس المراد بها الغلبة المطلقة , وإنما يكفي أن يكون الاحتراز أو الاستغناء عنه فيه مشقة وصعوبة نظراً لاشتباهه بغيره من الحلال والمباح واختلاطه به وامتزاجه معه بحيث يصعب الانفكاك عنه, كما هو ظاهر في بعض صور النجاسات والمستقذرات واختلاط الأموال.
ضوابط النظر في النوازل والمتغيرات في اجتهادات الفقهاء
د.صالح بن عبدالله بن حميد
د.صالح بن عبدالله بن حميد
مقدمة
لعل من المناسب التقديم بكلمات مختصرة, وإشارات موجزة حول ضوابط النظر في النوازل والمتغيرات في اجتهادات الفقهاء وكلام أهل الأصول - رحمهم الله – مربوطاً ذلك بخوض بعض المعاصرين المنتسبين إلى الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي, مما يستدعي ترسيخ النظر في الضوابط, وتأكيد ثوابت الشرع المطهر, مع وفائه التام بحاجة البشرية في كل مستجداتها ونوازلها.
نزلت شريعة الإسلام وحياً من عند الله تبارك وتعالى تحمل في أصولها ما يعالج قضايا الإعتقاد ويرسي قواعد العدل والمصلحة, والرحمة في الأحكام واستقامة السلوك.
وخلود الشريعة, وكمالها, وتمام النعمة بها يصدق بنصوصها وأصولها الثوابت منضماً إلى ذلك مجالات الاجتهادات النابعة من أصالة الفكر في تفهم النصوص ومقرراتها, وفي حسن تطبيقها في كل ما يجد في الحياة من وقائع, وما يلم بها من تطورات ومتغيرات بسبب إحداثات الفكر الإنساني, وتلوث البيئات والتحولات في المجتمع وما تقتضيه سنن الله في هذا.
والاجتهاد في تفسير النصوص أو النظر في الوقائع لتنال حكمها في الشرع, كل ذلك طريقه, إما النص في المنصوص عليه, وإما فهم النص فيما لم ينص عليه, ولا يكون ذلك إلا لذي الرأي الحصيف, المدرك لعلم الشرع الشريف.
وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي:
"وأشرف العلوم ما ازدوج فيها العقل والسمع, واصطحب فيه الرأي والشرع. وميدان هذا علم أصول الفقه, فإنه يأخذ في هذا سواء السبيل, فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول, ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له عقل بالتأييد والتسديد".
وذلكم هو ميدان الاجتهاد من أجل تحصيل الحكم الشرعي في مسألة غير من منصوصة.
وبتعبير آخر : هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
والاجتهاد يشمل الدقة في فهم النص, وفي طريقة تطبيق حكمه, أو في مسلك ذلك التطبيق على ضوء الملاءمة بين ظروف النازلة التي يتناولها النص, والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه.
يوضح ذلك شمس الدين ابن القيم في عبارة سلسة مبيناً نهج الصحابة - رضوان الله عليهم – فيقول:
"...فالصحابة - رضي الله عنهم – مثلوا الوقائع بنظائرها, وشبهوها بأمثالها, وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها, وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد, ونهجوا لهم طريقة, وبينوا لهم سبيلة".
وليس المقصود بالاجتهاد التفكير العقلي المجرد, فهذا ليس منهجاً مشروعاً, بل هو افتئاب على حق الله في التشريع, حتى ولو كان جاداً بعيداً عن الهوى, مادام أنه لم ينطلق من مفاهيم الشرع, ومبادئه, وأصوله, وحقائق تنزيليه, ومثله العليا ومقاصده الأساسية.
ومن أجل هذا فإن نطاق الاجتهاد الشرعي يتمثل في فهم النصوص الشرعية, وتطبيقاتها, ودلالتها, وقواعد الشرع المرعية.
يقول أبو حامد الغزالي:
"اعلم أن العلم في قسمين: أحمدهما شرعي, والآخر عقلي, وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها, وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها(ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).
فالعلوم الشرعية أكثرها عقلي؛ لأنه لا بد فيها من استعمال طلاقة العقل
وكذلك أكثر العلوم العقلية شرعي عند التحقيق, لأنه لابد من مراعاة قيد الشرع
والجمود والتقليد لا يكونان فقط بالكف عن استعمال العقل, وإنما يكونان أيضاً بالفصل بين ما هو شرعي وما هو عقلي, والاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ فعدم استعمال العقل في الشرعي جمود وتحجر, وكذلك عدم الاهتداء بالشرع في العلوم العقلية جمود وتحجر،
لأن الحق الواصل عن طريق الوحي لا يتعارض مع الحق الواصل عن طريق العقل الصحيح بالبحث والنظر".
مصادر التشريع
ومصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس,
ثم بعدها مصادر توصف بالمصادر التبعية, أي أنها مبنية على هذه المصادر ومنبثقة منها وفي إطارها لا تعدوها ولا تخرج عنها.
-من أبرز هذه المصادر التبعية وما يتعلق بها:
المصلحة المرسلة,
والعرف,
والاستحسان,
والاحتياط, وسد الذرائع,
وقاعدة الضرر والضرورات, وعموم البلوى
, والاستصحاب,
والبراءة الأصلية,
والمقام ليس مقام بسط للحديث عن هذه المصادر كلها.
-وفي مدخل هذا الموضوع يقال:
إن هذه المصادر من العرف, والاستحسان, والمصلحة هي المحك الدقيق والمرتقى الصعب في النظر فيما بسطه علماء الأصول والقواعد - رحمهم الله – حينما بحثوا في أعراف الناس وحاجاتهم وضروراتهم, وأثر المتغيرات والأحداث على استمساكهم بدينهم, وانتظام أمور معايشهم, فكان ذلك معتركاً دقيقاً يجب التثبت فيه على ما سوف يتبين إن شاء الله.
-وعليه فإن الحديث سيكون متناولاً مسألتين رئيسيتين:
أولاهما:
استعراض لبعض هذه المصادر التي تعد قواعد أساسية ينبني عليها التغير والتجديد, مع إنهاء الحديث في كل مصدر بما يضبطه بخصوصه.
ثانيتهما:
ضوابط عامة في النظر في المتغيرات.
أولاً :
استعراض لبعض المصادر في التشريع :
سوف يقتصر الكلام على المصادر التالية:
(المصلحة المرسلة – الاستحسان – سد الذرائع والاحتياط – عموم البلوى – العرف).
1-المصلحة المرسلة:
هي المصلحة التي شهد الشرع لجنسها, بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت له النصوص في الجملة. وليست هي المصلحة الغريبة التي لم يشهد النصوص لنوعها حتى تكون قياساً, ولا لجنسها حتى تكون استدلالاً مرسلاً, فهذه الأخيرة ليست حجة عند أحد من الأئمة, والغزالي الشافعي, والشاطبي المالكي يحكيان إجماع أهل العلم على رد المصالح الغريبة’ ويُدخلانها في باب الاستحسان الذي رده الشافعي – رحمه الله – وشدد النكير على القائلين به, وهو غير الاستحسان الذي روي عن مالك وأبي حنيفة – رضي الله عنهما – والأخذ به. فهذا الأخير استدلال بنص, أو إجماع, أو عرف, أو مصلحة في مقابلة عموم أو قياس. وهو الذي ستأتي الإشارة إليه.
غير أن الأخذ بالمصلحة المرسلة لابد فيه من أمور :
الأول :
أن تكون معقولة بحيث تجري على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول.
الثاني :
أن يكون الأخذ بها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين؛ بحيث لو لم يأخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج شديد.
الثالث :
الملاءمة بين المصلحة التي تعد أصلاً قائماً بذاته وبين مقاصد الشارع, فلا تنافي أصلاً من أصوله, ولا تعارض دليلاً من أدلته, بل تكون منسجمة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها, بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنها.
والمصلحة أو الاستصلاح باب واسع ومدخل عريض, قد يدخل منه من لا يفقه في الشريعة ولا يدرك مراميها, ومن أجل هذا منع منه من منع من المجتهدين خشية من هذا الباب.
ومن المقرر والمعلوم أن الشريعة تراعي مصالح العباد, وباب الاجتهاد مفتوح فيما لا نص فيه, ولكن للاجتهاد شروطه وللمصلحة ضوابطها وحدودها.
فليس مرد المصلحة إلى تقرير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد, فإذا حسب الناس أن التعامل بالربا – مثلاً – قد بات مصلحة نحتاج إليها, ولا يقوم أمر الناس إلا بها, فهو بمقتضى هذا الضر مصلحة حقيقية, وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم أن تتسع لقبول هذا الحكم, لأنه قد رأى ذلك علماء في الاقتصاد, وخبراء في التجارة من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها.
وقد يرى بل قد يتفق علماء التربية وعلماء النفس على أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب الأخلاق, ويخفف من شدة الميل الجنسي, ويمكن من استخدام كافة القوى البشرية المتاحة من أجل التنمية, فلا يبقى نصف المجتمع معطلا, فهو مصلحة ينبغي تحقيقها والشريعة تراعي تحقيق المصالح.
وقد يقول الأطباء : أن لحم الخنزير ليس بمستخبث, وإن أكله لا يعقب أي آثار سيئة في الخلق والجسم.
إن تقدير ما به يكون الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها, قد وضع ذلك في مقاصد الشريعة الخمسة وهي: حفظ الدين, وحفظ النفس, وحفظ العقل, وحفظ النسل, وحفظ المال.
وبناء عليه؛ فإن كل ما توهمه الناس مصلحة مما يخالف تلك الأسس العامة في جوهرها, أو الترتيب فيما بينها, أو يخالف دليلاً من الأدلة الشرعية من كتاب, أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح ليس من المصلحة في شيء, وإن توهمه من توهمه.
أما نتائج خبرات الناس وتجاربهم فيجب عرضها على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة, فما وافقها أخذ به, والحكم في ذلك للنصوص الشرعية ومقاصد الشريعة, وما خالف ذلك فيجب طرحه وإهماله واعتباره مصلحة ملغاة.
ويجب أن يفهم أن الشارع لم يلغ مصلحة دلت عليها تجارب الناس وعلومهم, بل الواقع أن تقدير هؤلاء المجربين والخبراء للمصلحة كان خطأ, صاحبه خلل نابع من هوى في نفس المجرب, أو خطأ في وسائل التجربة, أو نقص في الاستقراء, فنحن نتهم تقدير هؤلاء, ولا نتهم نصوص الشريعة.
نخلص من ذلك إلى أن الخبرات العادية, والموازين العقلية, والتجريبية المحضة لا يجوز أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد وتنسيقها.
إن مدار المصلحة التي ينبني عليها الحكم الشرعي هي المصلحة الشرعية, والمصلحة الشرعية ليس لها طريق غير الوحي.
أما المصلحة الدنيوية فلا اعتبار لها في نظر المسلم عند مخالفتها للنص الشرعي.
2-الاستحسان:
عرفه ابن رشد المالكي فقال:"إنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه, فيعدل عنه في بعض المواضع, لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع".
وعرفه أبو الحسن الكرخي الحنفي حيث قال:"هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول".
فالاستحسان نوع من الترجيح بين الأدلة, وحقيقته كما يلاحظ, وكما يصرح به كثير من الأصوليين أنه أخذ بأقوى الدليلين.
أنواع الاستحسان:
ينقسم الاستحسان من حيث ابتناؤه على الأدلة الشرعية إلى أربعة أقسام:
أ.الاستحسان بالنص:
وذلك يجري في كل أنوا العقود التي قالوا أنها على خلاف القياس كالسلم, والإجارة, والقرض ونحوها. وهي استحسان بالنص لأنها قد ثبتت بنصوص شرعية على غير وفق القاعدة العامة من عدم صحة بيع المعدوم, وعقود الربا, ونحو ذلك. وأغلب إطلاقات الاستحسان في كتب الفروع تتصرف إلى هذا النوع, وعلى الخصوص في فروع الحنفية,فيقولون هذا جائز استحساناً, ويسمونه الاستحسان بالنص.
ب.الاستحسان بالإجماع:
أي أن الاستحسان هو الإجماع كما في مسألة الاستصناع.
ج- استحسان الضرورة:
كما في مسألة الحياض والآبار؛ ووجه الاستحسان في هذه المسألة أن الماء إذا خالطته نجاسة ولو كان كثيراً فإنه ينجس مادام ليس جارياً, ولكن عفي عن ذلك استحسانا للضرورة, وبيان ذلك: أن القياس يأبى طهارتها. لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء, فلا يزال يعود وهو نجس, ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي, وكذلك خروج بعضه عن الحوض, وكذا الماء ينجس بملاقاة الآنية النجسة, والنجس لا يفيد الطهارة, فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة, فإن الحرج مرفوع بالنص. وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس.
د- الاستحسان بمعنى القياس الخفي:
وقد سمي قياساً خفياً في مقابلة القياس الجلي, وهو القياس المصطلح عليه. والاستحسان بهذا المعنى يقصدون به ما قوي أثره. ومن أمثلته طهارة سؤر سباع الطير, فالقياس الجلي أن سؤره نجس, لأنه من السباع. ودليل النجاسة حرمة أكل لحمه كسائر السباع. وفي الاستحسان هو طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا كالصيد, وكذلك الانتفاع بجلده وعظمه, ولو كان نجس العين لما جاز كالخنزير, وسؤر سباع البهائم إنما كان نجساً باعتبار حرمة الأكل لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها, ولعابه متولد من لحمها, وهذا لا يوجد في سباع الطير لأنها تأخذ الماء بمنقارها, ومنقارها عظم, وعظم الميتة طاهر, فعظم الحي أولى. فصار هذا الاستحسان وإن كان باطناً أقوى من القياس وإن كان ظاهراً, وهذا النوع من الاستحسان هو الذي يغلب إطلاقه عند الأصوليين.
3. سد الذرائع والاحتياط:
سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة أو وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه, فما كان وسيلة إلى الحرام يحرم, وإن كان في أصله حلالاً, ومعنى هذا الأمر الجائز في الأصل يمنع منه في الحالات التي يؤدي فيها إلى مالا يجوز. فعقد البيع حلال مشروع في أصله لقوله تعالى ( وأحل الله البيع )
ولكن قاعدة سد الذرائع تقتضي بطلان هذا البيع إذا قصد به المحرم, أو كان الباعث الدافع إليه غير مشروع, كما في بيع السلاح لمن يقتل مسلماً, أو لأهل الحرب, وبيع العنب لمن يتخذه خمراً.
أما الاحتياط :
"فهو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه من حرام أو مكروه".
مجال الأخذ بالاحتياط:
والمكلف يأخذ بالاحتياط في مجالين:
الأول :
تحقق الشبهة.
الثاني :
حصول الشك في الحكم الشرعي.
المجال الأول: تحقق الشبهة:
الشبهة التي تعرض للمكلف في الأحكام الشرعية قسمان:
القسم الأول: الشبهة الحكمية:
وهي التي تقع في الحكم الشرعي بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن, وهي متوجهة إلى الحكم الشرعي نفسه من حل أو حرمة وغيرهما من أقسام الحكم الشرعي, لذا سميت بالشبهة الحكمية, وهذا يحصل غالباً حين تتعارض الأدلة لدى المجتهد.
القسم الثاني: الشبهة المحلية:
وهي التي ترد على المحكوم فيه الذي هو محل الحكم من حيث دخوله تحت حكم الشارع من حل أو حرمة أو غير ذلك. كاشتباه ميتة بمذكاة ومحرمة بأجنبيات وهو أنواع:-
1-اشتباه بعدد محصور: كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو مذكيات محصورات, أو رضيعة بعشر نسوة فهذه شبهة يجب اجتنابها بالاتفاق.
2-حرام محصور بحلال غير محصور: كما لو اختلطت الرضيعة بنساء البلد, فلا يجب اجتناب نكاح نساء أهل البلاد.
3-حرام لا يحصر بحلال لا يحصر: كاختلاط الحلال بالحرام في أسواق الناس, والأسواق فيها المغصوب, والمسروق, والربوي, مما يقل ويكثر, حسب ورع أهل الزمان, ولا يقال بالمنع من التعامل مع أهل الزمان, أو البلد ما لم يقترن بالأعيان علامات تدل على أنه من الحرام, فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام, فتركه ورع, وأخذه حلال, لا يفسق به آكله.
المجال الثاني:
الشك في الحكم الشرعي الطارئ بسبب الشك في الواقع: فيطرأ الشك في الحرمة والوجوب أو الإباحة فيحتاط المكلف لنفسه فانه لا يخرج من عهدة الواجب- مثلاً- إلا بيقين أو ظن غالب. كالشك في عدد الركعات .
والنظر في ذلك في أربعة أقسام:
1- التحريم معلوم ثم يطرأ الشك في الحل, فهذه شبهة يجب اجتنابها, ويحرم الإقدام عليها, كما لو رمى صيداً فوقع في الماء فيخرج ميتاً, ولا يدري هل مات بالغرق, أو بسبب جرح الرماية.
2- الحل معلوم ثم يطرأ الشك في التحريم, حكمه الحل, فلا ينجس الماء بمجرد ظن النجاسة.
3- الأصل التحريم ثم يطرأ ظن غالب على الحل, كمن يرمي صيدا فيغيب عن ناظره ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى أثر رميه, فهو حلال, وان احتمل أنه مات بسبب شدت السقوط.
4- الأصل الحل ثم يطرأ ما يفيد غلبت الظن التحريم, كما لو رأى حيواناً يبول بماء كثير ثم وجد الماء متغيراً واحتمل أن يكون الماء قد تغير بطول المكث فيحكم بنجاسة الماء.
على أن الاحتياط في جملته مطلوب فيما علم أمره وتحقق فيه يقين اختلاط الحلال بالحرام أو ظن غالب, وذلك بقرائن وعلامات توصل إلى ذلك, كما لو كان في بلاد غير المسلمين أو مع فساق لا يتورعون عن اقتراف المنهيات, أما إذا كان في ديار المسلمين, ولم يظهر ما يدعوا إلى الاشتباه فلا ينبغي التدقيق والإلحاح في الأسئلة مع أعيان المسلمين, بل قد يصل الأمر إلى تحريم السؤال إذا كان فيه إيذاء للمسلم المستقيم.
4-عموم البلوى :
يظهر عموم البلوى في موضعين:-
الأول : ماتمس الحاجة في عموم الأحوال , بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة .
الثاني: شيوع الوقوع والتلبس , بحيث يعسر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة.
ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة, وفي الثاني ابتلاء بمشقة الدفع.
الضابط في عموم البلوى :
يرجع النظر في عموم البلوى إلى ضابطين رئيسين:-
الأول:
الضابط في نزارة الشيء وقلته:
أي أن مشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به قد يكون نابعاً من قلته ونزارته, ومن أجل هذا عفي عن يسير النجاسات, وعن أثر الاستجمار في محله, عما لا يدركه الطرف , وما لا نفس له سائلة ونيم الذباب(ما يخرج من فضلاته), وما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز عنه , وما ينقله الذباب من العذرة وأنواع النجاسات.
الثاني:
كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره:
كما أن عموم الابتلاء ومشقة التحرز قد تكون نابعة من تفاهة الشيء ونزارته, كذلك قد يكون الأمر لكثرته وشيوعه فيشق الاحتراز عنه ويعم البلاء به.
وقد نبه الغزالي إلى أن الغلبة التي تصلح عذراً في الأحكام ليس المراد بها الغلبة المطلقة , وإنما يكفي أن يكون الاحتراز أو الاستغناء عنه فيه مشقة وصعوبة نظراً لاشتباهه بغيره من الحلال والمباح واختلاطه به وامتزاجه معه بحيث يصعب الانفكاك عنه, كما هو ظاهر في بعض صور النجاسات والمستقذرات واختلاط الأموال.