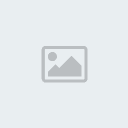من أقرّ بظواهر الإسلام هل يقضى بإيمانه أم لا؟
العلامة : صديق حسن القنوجي:
نعم، من أقر بظواهر الإسلام قُضي بإيمانه، وإن لم يبحث عن جميع العقيدة، وهذا هو الحق الذي لا يمتري فيه إلا مكابر، وما أبعد ما جزم به المتعنتون من توقف الإسلام على معرفة حقائق ودقائق من علم الكلام لا يفهمها إلا المتدربون في المعارف العلمية، والشريعة السمحة السهلة عن هذا بمعزل، ولكن البِدَعَ تأتي بما لم ينزل به سلطان، ولا قام عليه برهان، من سنة ولا قرآن، على أن هؤلاء المتعنتين لم يظفروا من إكبابهم على تلك الدقائق بسوى الحيرة، كما أقر به كثير من محققيهم، والحيرة جهل، لأن العلم هو ما يتجلّى به الأمر، فكيف يتوقف الإسلام على معارف غاية ما يستفيده من تبحر فيها أن يكون جاهلاً. قال رباني العترة الكرام، زمخشري أهل البيت عليهم السلام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب ((البرهان القاطع في إثبات الصانع)): هذا الرازي، سلطان العلماء وحجة الحكماء وفخر الملة وشعلة الذكاء وفيلسوف الإسلام، بعد أن انتهج الطرق الفلسفية وسلك المسالك الخفية ينشد في كتابه ((النهاية)):[/b]
العلم للرحمن جل جلالـه وسواه في جهلاته يتغمغم
أين التراب من العلوم وإنما يسعى ليعلم أنـه لا يعلم
ويقول في وصيته التي مات عليها: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. وقال بعضهم:
وكم في البرية من عالم قوي الجدال دقيق الكلم
سعى في العلوم فلمَّا يفد سوى علمه أنه ما علم
فبهذه الأمور علمنا أن الأنبياء ما أخذوا عقائدهم عن النظر ولا كانوا بحيث يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، فلم يبق إلا أنهم علموا ما دانوا به علماً ضرورياً.
وقال أيضاً في كتاب: ((ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان في أصول الأديان وبيان بطلان ذلك بإجماع الأعيان بأوضح التبيان)) ما حاصله: والأولى عندي الاحتياط في مسائل الفقه ما أمكن والتوقف في مسائل الكلام، قال: وكان عبد الله بن موسى يكرهُ الكلام فيما أحدث الناس، وكان إذا ذُكر له رجل ممن يتكلم قال: ((اللهم أمِتنا على الإسلام)) ويمسك. قال: فرأوا الجمل والقول بظاهر القرآن كافياً مؤدياً للعباد إلى الله تعالى فتمسكوا بذلك، فينبغي لمن أمَّ الدين وقصد إلى الله، الاقتداء بهم والتمسك بسبيلهم، أو يكونوا لم يعتقدوا في ظاهر الأمر وباطنه إلا القول بظاهر القرآن والجمل المجمع عليها، فقد يجب الاقتداء بهم أيضاً في ذلك.
قال: وهذا أسلوب الأنبياء والأولياء والأئمة والسلف كلهم في النظر، وخالفهم بعض المتكلمين وأنواع المبتدعة فتكلموا وتعمقوا وعبروا عن المعاني الجلية بالعبارات الخفية، ورجعوا بعد السفر البعيد إلى الشك والحيرة والتعادي والتكاذب، وقد اعترف كبراء المتكلمين بالوقوع في الحيرة والأمور المشكلة المتعارضة. قال صاحب كتاب ((الإمام)):
تجاوزت حد الأكبرين إلى العلى وسافرت واستبقيتهم في المفاوز
وخضت بحاراً ليس يدرك قعرها وسـيرت نفسي في قسـيم المفاوز
ولججت في الأفكار ثم تراجـع اختياري إلى استحسان دين العجائز
وقال شيخنا وبركتنا الشوكاني في ((وبل الغمام)): وقد كنت – وأستغفر الله – في أيام حرصي على التحصيل مشغوفاً بالوقوف على حقيقة ما دوّنه علماء الكلام من تلك القوانين فأتعبت نفسي فيها برهة من الزمن، ولما ظننت أني بلغت منها الغاية:
وغايـة ما حصلتـه من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما عَلِمَ من لم يلـق غير التحير
والذي أعتقده الآن هو ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بما قامت عليه الأدلة الصحيحة كائناً ما كان، وما تعارضت فيه الحجج ولم أهتد إلى الراجح، أو كان من متشابه الكتاب، أو استلزم ما لا يقوى القلب على القول به، كبعض أحاديث الصفات فأكل أمره إلى الله مع الإيمان بظاهره، ولم يتعبد الله أحداً من عباده بمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وبما يكون منه عزّ وجل وما قد كان، بل أرشدهم إلى قصور أفهامهم عن ذلك بقوله: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً}([1][1])، وبقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء}([1][2])، وأمرهم في هذه الدار بأعمال يؤدونها ونهاهم عن أفعال يفعلونها، فليتهم شغلوا أنفسهم بذلك، وتركوا ما ليس من شأنهم، فإن مسمى الإسلام والإيمان لا يتوقف إلا على تأديةِ ما أُمروا به، وترك ما نهوا عنه. وقد أوضح لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه جبريل من السماء في صورة رجل فسأله عن الإسلام فقال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان))، وسأله عن الإيمان فقال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره))، وسأله عن الإحسان فقال: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك))، ثم غاب السائل وهو جبريل، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم))([1][3])، وهذا الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، فانظر – هداك الله – ما فسر به صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان، فإنه حاصل لكل عامٍ فضلاً عن عالم، وانظر كيف قال: ((أن تؤمن بالله))، ولم يقل: أن تعرف ذات الله وصفاته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل أمر ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو ردّ، فإذا سمعت من يقول: لا يكون الرجل مسلماً أو مؤمناً إلا بأن يفعل كذا، أو يقول كذا، أو يعلم كذا، أو يعتقد كذا فاعرضه على هذا القول المحمدي الذي وقع جواباً عن عظيم الملائكة جبريل بين يدي رب العزة لقصد تعليم هذه الأمة المرحومة، فإن وافقه فبها ونعمت، وإن خالفه فقل: هذا خلاف بينك أيها القاتل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعد القيامة والسلام.
ولست أعجب من غلاة المتكلمين وجفاة المتعجرفين من علماء أصول الدين، فإنهم لا يعرفون من السنة المطهرة نقيراً ولا قطميراً، ولهذا خالفوا منها ما تواتر، إنما العجب ممن له تمسك بالأقوال المصطفوية واشتغال بالأحاديث النبوية، كيف يؤثر عليها قول واصل بن عطاء([1][4]) وعمرو بن عبيد([1][5]) وأبي الهذيل([1][6]) وأضرابهم {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}.
وإنما المعتبر في الإسلام والإيمان والنجاة هو أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا يحيط به علماً، فعلمه بأنه لا إله إلا هو هو التوحيد، وعلمه بأنه ليس كمثله شيء هو التنزيه عن التشبيه، وهو يستلزم الفرق بين ذاته جلّ جلاله وبين سائر الذوات، وعلمه بأنه لا يحيط به علماً هو التعظيم المستلزم لإراحة النفس عن الوقوع في الدعاوي التي ليست في وسع الإنسان المستلزمة لعدم التعظيم، والرد للقرآن، كما قاله بعض المتعجرفين من المتكلمين: إنه لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلمه، وأفرط في الفرية على الله حتى أقسم على ذلك.
فمن كان على الصفة التي شرحناها فهو العارف بالله، وأما معرفة التدقيقات المبنية على شفا جرف هار، التي شغل بها المتكلمون أنفسهم وشغّلوا من بعدهم فما تعبد الله بمعرفتها أحداً من خلقه، فقد درج خير القرون وهم منها في عافية، فإن كان ذلك هو المراد فقد كلف العباد ما لم يكلفهم، وأفرط في ذلك حتى جزم بأن التوبة لا تنفع من لم يعلم به، وجعل من جملة ما يتوقف قبول التوبة عليه، معرفة ما يجوز على الله من الأسماء والصفات وما لا يجوز. وهذا حدٌّ لا يبلغ إليه على مصطلح المتكلمين إلا من شغل شطراً من عمره في تلك المعارف، وأطم من هذا وأعم اعتبار معرفة ما يجوز أن يفعله وما لا يجوز وما يتفرع على ذلك، فإن معرفة هذا على التحقيق باعتبار الاصطلاح الحادث والعلم المبتدع لا تحصل إلا لمن كان مبرزاً في العلوم محققاً لمنطوقها والمفهوم، فيا ويل العامة الذين هم جمهور هذه الأمة المرحومة إن صحّ اشتراط ما ذكروه في قبول التوبة، ويا ويح من لم يتبحر في علم الكلام ومقدماته من علم اللطيف الموضوع لذلك الهذيان الطويل العريض في شأن الجسم والجوهر والعرض، وهكذا فضلات العلم وفضوله لا تثمر أشجارها إلا مثل هذه الثمرة المقتضية للحيلولة بين عباد الله وبين التوبة إلى الله.
وأنت إذا أمعنت النظر في هذا الشرط وجدته لم يقم به أحد من هذه الأمة بالاتفاق، فإن الأشعرية لم تقم به في اعتقاد المعتزلة، والمعتزلة لم تقم به في اعتقاد الأشعرية.
ومن خرج عن الطائفتين وهم السواد الأعظم لم يقم به في اعتقادهما والعكس، فلم يبق إلا سد باب التوبة الذي فتح الله أبوابها ما دام يعبد في الأرض.
والحاصل: أن علم الكلام باعتبار الاصطلاح ليس هو من العلم المعتبر في كمال الإسلام والإيمان في ورد ولا صدر، وهذا لا يعرفه على التحقيق إلا من طوّل الباع في هذا العلم، ولهذا عرف حقيقته من عرفها من أئمته المتبحرين فيه حتى تراجع اختيارهم إلى استحسان دين العجائز. اللهم اهدنا للاشتغال بما كلفتنا بمعرفته واعصمنا عن الزيغ والزلل بحولك وطولك، انتهى.
وقال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في ((ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان)): أنها وردت نصوص يقتضي العلم أو الظن أن الخوض في علم الكلام على وجه التقصي للشُّبَهِ والإصغاء إليها، والتفتيش عن مباحث الفلاسفة والمبتدعة المشككة في كثير من الجليات مضرة عظيمة، ممرضة لكثير من القلوب الصحيحة. ودفع المضرة المظنونة واجب عقلاً، وقد شهدت بذلك التجارب مع النصوص، وضل بسببه اثنتان وسبعون فرقة من ثلاثٍ وسبعين.
وهذه الإشارة بالنصوص إلى مجموع أشياء كثيرة، منها: النواهي عن البدع، ومنها: النواهي عن المراء مطلقً، ومنها: النواهي عن المراء في القرآن خاصة، ومنها: النواهي عن المراء في القدر خاصة، ومنها: النهي عن التفكر في الله، ومنها: الأوامر عند الوسوسة بما ينافي طرائق أهل الكلام، وفي ذلك خمسة عشر حديثاً في الكتب و((مجمع الزوائد)) أشرت إلى بيانها في ((العواصم))، ومنها: أحاديث الإسلام والإيمان المتواترة التي يقتضي قواعد الكلام منافاتها إلا مع التأويلات المتعسفة، ويشهد لذلك في كتاب الله تعالى قوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِى ءايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَـٰهُمْ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّـا هُم بِبَـٰلِغِيهِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّـهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ}([1][7])، فهذا مطابق لما ورد في الحديث من الأمر بالاستعاذة بالله عند السؤال عن الشبهة. وقال تعالى: {قَدْ جَاءكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ}([1][8])، وقال: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ}([1][9]) ولم يقل: بعد المتكلمين، والحمد لله رب العالمين انتهى.
وبالجملة فعلم الكلام ليس من علوم الرسل ولم تأت به الأنبياء وإنما الذي جاءوا به هو الإسلام المطابق للقرآن، والإيمان الموافق بالسنة، والإحسان الناطق به الحديث بأفصح لسان وأبين بيان، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
وأما أرباب النظر فإنهم يجدون الشكوك عند ورود الشُّبَهِ حتى إن بعض علماء الكلام ارتد إلى الكفر بعد الإسلام ونعوذ بالله منه. وقد ذكر السيد الجليل يحيى بن منصور اليمني تدقيق المتكلمين وعلومهم في أصول الدين في قصيدة طويلة منها قوله:
ويرون ذلك مذهبـاً مستعظمـاً عن طـول أنظار وحسن تفكر
ونسوا غنا الإسلام قبل حدوثهم عن كل قـول حادث متأخر
ما ظنهم في المصطفى في تركـه ما اسـتنبطوه ونهيـه المتقـرر
أيكون في دين النبي وصحبــه نقص فكيف به ولمـا يشعـر
ما باله حتى السـواك أبـانـه وقـواعد الإسلام لم يتقرّر
إن كان رب العرش أكمل دينه فأعجب لمبطن قوله والمظهر
أو كان في إجمال أحمـد عيبه فدع التكلف للزيـادة واقصر
ما كان أحمد بعد منعٍ كاتمـاً لهدايـة كـلا ورب المشـعر
بل كان ينكر كل قول حادث حتى الممات فلا تشك وتمتدِ
يكفيك من جهة العقيدة مسلم ومن الإضـافة أحمدي المأثر
قال شيخنا وبركتنا الشوكاني في ((الفتح الرباني)): ومن هذا القبيل أي من المشتبهات التي هي بين الحلال والحرام المسائل المدوّنة في علم الكلام المسمى بأصول الدين، فإن غالب أدلتها متعارضة، ويكفي المتقي المتحري لدينه أن يؤمن بما جاءت به الشريعة المطهرة إجمالاً من دون تكلف لقائل ولا تسعف لقال وقيلَ، وقد كان هذا المسلك القويم هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
قال: فلقد تعجرف بعض علماء الكلام بما ينكره عليه جميع الأعلام، فأقسم بالله أن الله لا يعلم من نفسه غير ما يعلمه هذا المتعجرف، فيالله هذا الإقدام الفظيع والتجارؤ الشنيع، وأنا أقسم بالله أنه قد حنث في قسمه وباء بإثمه وخالف قول من أقسم به في محكم كتابه {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً}([1][10])، بل أقسم بالله أن هذا المتعجرف لا يعلم حقيقة نفسه وماهية ذاته على التحقيق فكيف يعلم بحقيقة غيره من المخلوقين فضلاً عن حقيقة الخالق تبارك وتعالى؟!
قال: ومن أعظم الأدلة الدالة على خطر النظر في كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رجلاً أفرغ فيه وسعه، وطوَّل في تحقيقه باعه، إلا رأيته عند بلوغ النهاية والوصول إلى ما هو من الغاية يقرع على ما أنفق في تحصيله سن الندامة، ويرجع على نفسه في غالب الأحوال بالملامة، ويتمنى دين العجائز، ويفر من تلك الهَزاهِز، كما وقع من الجويني، والرازي، وابن أبي الحديد المعتزلي والسهروردي المقتول، والغزالي وأمثالهم ممن لا يأتي عليه الحصر.
فإن كلماتهم نظماً ونثراً في الندامة على ما جنوا به أنفسهم مدونة في مؤلفات الثقات. هذا وقد خضع لهم في هذا الفن الموالف والمخالف، واعترف لهم بمعرفته القريب والبعيد، نعم أصول الدين الذي هو عمدة المتقين ما في كتاب الله تعالى الذي {لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ}([1][11])، وما في السنة المطهرة. فإن وجدت فيها ما يكون مختلفاً في الظاهر فليسعك ما وسع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو الإيمان بما ورد كما ورد، وردُّ علم المتشابه إلى علاّم الغيوب ومن لم يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه، انتهى.
وإن شئت الزيادة على ذلك فارجع إلى كتاب ((العواصم والقواصم)) ومختصره كتاب ((الروض الباسم في الذبّ عن سنة أبي القاسم)) وكتاب ((ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان)) وكتاب ((البرهان القاطع على إثبات الصانع)) للسيد العلامة الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، ومؤلفات شيخنا عزّ الإسلام والمسلمين وسند الحفاظ المتقنين القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني، وكتابنا ((قصد السبيل إلى بيان سواء السبيل)) وغير ذلك مما ألّف في هذا الباب، ففيه ما يكفي الشيخ ويشفي الشاب والله الهادي إلى الصواب.