ما أحوج العالم اليوم في اصطراعه, واضطرابه, وبلبلته, واعوجاج خطاه, وحيرة قادته, وثورة شعوبه, إلى قبس من نور الإسلام الخالد, يبدد به الظلمة, ويبصره عواقب هذا النضال, الذي يوشك أن يعيد المأساة, ويذهب من جديد, بما ادخره من أخضر ويابس, ونفس ونفيس, ويلقي بها كلها طعمة لنيران الحقد والانتقام والطمع والهوى.
وما أحوجنا في مشكلاتنا الاجتماعية التي تنعقد يوما بعد يوم ويأخذ بعضهم برقاب بعض, ويتسع خرقها على الراقع إلى أن نسمع كلمة الإسلام فيها, لنتبين وجه الصواب في علاجها, وسلامة المبادئ التي ترد إليها الحلول القويمة, مع رعاية الظروف وما استجد في الحياة من مطالب.
فلنعالج بالقوة التي أضفاها الإسلام على الروح, فمكن لها وجعل لها الغلبة على نزوات المادة, دون أن يقل من شأن هذه المادة ما دامت تؤتى من وجهها, وتصرف في مصارفها الصحيحة, ولنعالج حالنا بوسائل الإسلام في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تهدد كياننا, وتقوض أركان نهضتنا.
وما أحوجنا لتعرف وسائل الإسلام في دعم الأسرة, والإحاطة بقدر ما حبا به هذه الخلية الحية في جسم الأمة, وما وفر لها من أسباب الرخاء والاستقرار, وما جنبها من عوامل الشقاء والانحلال.
وما أحوجنا إلى تعرف وسائل الإسلام في طرائق المعاملات, وكيف حض على احترام العهود والعقود, وكيف نظم البر ودعا إليه, وجعله أقرب قربات إلى الله تعالى.
وما أحوجنا أن نعرف أيدت أحدث النظريات الحديثة في التربية والطب والاجتماع, نظرة الإسلام الثاقبة في تربية الجسم والعقل والخلق, وما حرم من المتاع صونا للروح والجسد من آفة الانحلال والمرض, وما أحل منه رغبة في تصفية الذوق, وتهذيب النفس, وإذكاء الشعور الطيب, وما حرم من عبث ليجعل النفوس بمنجاة عن الإسفاف والفسوق, واللهو الفارغ, ومغريات الشهوات الدنية.
لقد تناولت تعاليم الإسلام حياة الإنسان في جميع أحواله, تناولته غنيا ففرضت في أمواله حقاً لطائفة من المجتمع {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}, فرض الإسلام على الأغنياء الزكاة وأوجب عليهم بذل المال أيضا في ميادين ومناسبات أخرى: كصدقة الفطر, وكفارة اليمين, وغيرها من الكفارات, وندب إلى الإنفاق في سائر وجوه البر في آيات أخرى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم}, مما يكفل إنعاش الفقراء وهنائهم ورفاهيتهم, ودعت إلى التلطف في إيصال الصداقات, واستحسنت في أن تكون في خفية حتى لا يجرح من شعور الفقير ولا ينال من كرامته, وفي القرآن الكريم: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ}.
لهذا التشريع غايته السامية فهو (إلى أنه؟؟) تعاون بين الغني والفقير, يسد من حاجة الفقير, ويخفف عنه المرارة والحرمان, وهو بالتالي إصلاح لحال المجتمع من الانهيار, وتناولت تعاليم الإسلام, وحياة الإنسان عاملا وصاحب عمل, وفلاحا وصاحب أرض, وموظفا ومستخدما, ورئيسا ومرؤوسا, فدعت الجميع إلى إتقان العمل والوفاء والإخلاص والأمانة, وتجنب الخيانة والغش, وعدّت الغاش والخائن شاذّاً عن الجماعة الإسلامية, كما كرّهت الشريعة أن يخلد الإنسان إلى البطالة, ودعت إلى العمل, وألحّت الدعوة, وفي الحديث: "لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه".
وتناولت تعاليم الإسلام حياة الإنسان جاهلا ففرضت عليه أن يتعلم من العلم ما يحتاج إليه في شؤون دينه ودنياه, وتناولته عالما, ففتحت له أبواب العلم على مصارعها ليعرف أسرار الله في خلقه, وليستنبط من هذه الأسرار المبادئ العلمية الصحيحة التي تسهل لله سبل العيش, وترفه عليه وسائل الحياة, وأغرته بالاستزادة من العلم {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً}, {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}, وتناولت تعاليم الإسلام حياة الإنسان في بيعه وشرائه ومطعمه وملبسه وحديثه وحركاته وسكناته, ووضعت له فيها جميعا أسمى مبادئ اللياقة والذوق, وهكذا لم يترك الإسلام شاردة ولا واردة إلاّ تعهدها ووضعها, بحيث تكفّل سعادة الإنسان وهناءه, فالصلاة مثلا حيث يقف العبد أمام رب العالمين يناجيه, فبين الفينة والفينة مجبور على أن يتذكر أن له ربا يراقبه على حركاته وسكناته, يراقبه على أعماله صغيرها وكبيرها, عظيمها وحقيرها, {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم}, فكيف يكذب؟ أم كيف يخون؟ أم كيف يسرق؟ أم كيف يغش؟ أم كيف يتغافل عن الواجب الملقى على عاتقه؟ وهكذا فالصلاة وحدها جعلت من الإنسان ملكا من الملائكة {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر}, ناهيك عن المساواة التي في الصلاة حيث عجزت عنها أعظم النظم الحديثة, فيسجد الغني والفقير والعظيم والكبير والحقير والصغير والجندي إلى جانب القائد, ليس هناك رأس مرتفع على رأس, بل كلها خاضعة لله وحده, ويقفون بجانب بعضهم, ليس هناك أمكنة مخصصة لأناس (من لا يخضع للخالق يخضع لأحقر مخلوقاته, ومن يخضع للخالق تتلاشى في عينيه قدرة المخلوقات), فهذا عرض موجز لبعض التعاليم الإسلام في بعض شئون الحياة, وليس من المستطاع عرض كل ما احتوته الشريعة الإسلامية في هذه النواحي وفي غيرها, ولكن من المستطاع أن نقول إنها كلها على هذا النمط من السمو, وأنها تهدف إلى سعادة الفرد والمجتمع, وتوفير حياة الأمن والاستقرار للبشرية عامة, وأنها أسس صالحة لأرقى مدينة تتطلع إليها الإنسانية.
وقد يقول قائل: إذا كانت التعاليم الإسلام كافية في إصلاح البشرية وشفائها, فلماذا نرى أثرها قد تخلف عنها ؟
ولهؤلاء أقول: ليس العيب عيب الشريعة, ولكن الوزر كل الوزر على الذين انحرفوا عنها, وعادوها وظنوا جهلا منهم أنها تقف بعيدا عن مقتضيات الرقي الصحيح...
ومثل الشريعة الإسلامية للبشر مثل الدواء الشافي يصفه الطبيب الماهر للمريض, ولكن المريض لا يتعاطاه تهاونا منه, فلا يكون العيب إذن عيب الطبيب, ولا عيب الدواء, ولكن العيب كله عيب المريض المتهاون في تعاطي الدواء.
ويزداد الأمر وضوحا لهؤلاء أن نذكّرهم بحال الأمة الإسلامية في صدر الإسلام, وما بلغته من مجد, وما بهرت به العالم من نهوض علمي واجتماعي في زمن وجيز لا يزال مثار عجب العلماء والفلاسفة, ومحل بحثهم
وليس له من سر في حقيقة إلاّ أن أولئك المسلمين السابقين أخلصوا لدينهم, وأخذوا بأحكامه وآدابه بجد وإيمان, فقادهم إلى مواطن المجد وأنزلتهم منازل السيادة والعز {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِه,ِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.
للشيخ إبراهيم السلقيني
المدرس في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
http://www.iu.edu.sa/Magazine/2/12.htm |
|
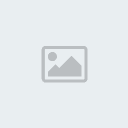

 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

